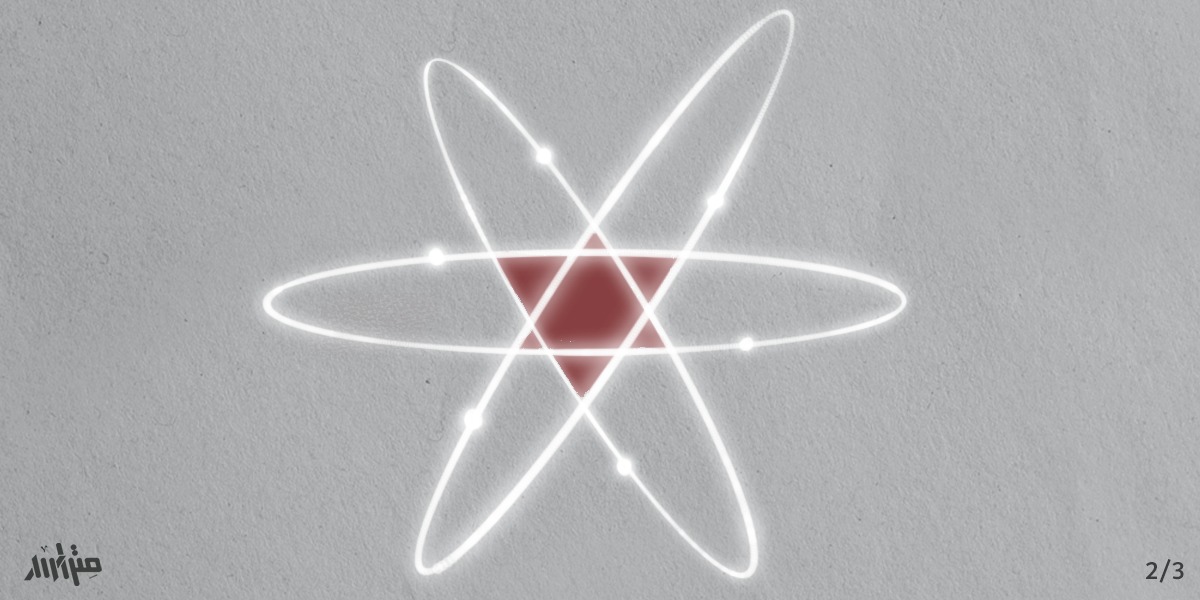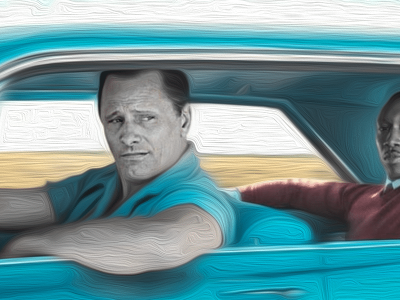الجزء الأول، هنا.
"مستقبل إسرائيل لا يعتمد على ما يقوله غير اليهود، وإنما على ما يفعله اليهود"، بن غوريون، 1955.
مِن الذرّة إلى الدولة وبالعكس
يتشابه الميلادُ السياسيّ لِـدولة الاحتلال الإسرائيلي مع الميلاد الهندسيّ للقنبلة الذرّية على أكثر من مستوى، بعضها يبدو نتاج الصدفة، لكن العلاقة بين الاثنين ليست مسألةً عَرَضية. زمنيّاً، حصل الأمران في نفس النافذة التاريخيّة؛ القنبلة في حزيران/ يونيو 1945 و"إسرائيل" في أيار/ مايو 1948. كلاهما أيضاً يَدين بالكثير للحرب العالمية الثانية، وكلاهما لعبت النازيةُ دوراً هائلاً في تمكينهما. وحتى على صعيد الجذر التاريخي، يكاد الحدثان ينبعان من لحظةٍ واحدة؛ المؤتمر الصهيوني الأوّل عُقد في بازل عام 1897، والتجربة المفتاحية التي أطلقت أبحاثَ الانشطار النوويّ كانت لهنري بيكاريل في باريس عام 1896.
لكن التشابه يمضي أبعد من ذلك وتصبح معه "إسرائيل" والقنبلةُ وجهين في مكعبٍ واحد. كان حاييم وايزمان كيميائياً قبل أن يكون محترفاً للسياسة، وكان على صداقةٍ قويةٍ بألبرت آينشتاين، المرشح السابق لرئاسة دولة الاحتلال. أوائل الحرب العالمية، وقّع آينشتاين رسالةً مكتومةً للرئيس روزفلت تدعوه لإطلاق مشروعٍ نوويّ استباقاً لتحركٍ ألمانيّ بهذا الاتجاه، وقادت الرسالة –على نحوٍ عمليّ مباشر- لميلاد مشروع مانهاتن وتصنيع القنبلة الذرّية الأولى.1مشروع مانهاتن: المشروع الذرّيّ الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية والذي قاده الجنرال ليزلي غروف وأدار جانبه التقني روبرت أوبنهايمر.

لم يكن آينشتاين من كَتب الرسالة بنفسه؛ مَن كتبها كان فيزيائياً مَجَريّاً يدعى (زيلارد)، وهو يهوديٌّ آخر عمل في برلين قبل أن يتركها بعد وصول النازيين للحكم. والواقع أنَّ عدداً من أهم فيزيائي مشروع مانهاتن أتوا من هذه الخلفية تحديداً: أوروبيّون يهود فرّوا من القارة العجوز بعد وصول النازيين للحكم، وانخرطوا في صناعة القنبلة النوويّة الأولى بدافعٍ ثأري لا يحتاج توضيحاً. كان مدير المشروع الذريّ الأميركي، روبرت أوبنهايمر، يهوديّاً، ومثله كان "الأب الروحي للقنبلة الهيدروجينية"، إدوارد تيلر. وحتى الإيطالي إنريكو فيرمي، الملقّب بمهندس العصر الذرّي، هاجر للولايات المتحدة حمايةً لزوجته اليهودية من قوانين عنصريّة سُنّت بوقتها. على قارعة هذه المشهدية التاريخية، التي يتقاطع فيها الفيزيائيُّ بالسياسي، شُطِرَت الذرّة وحَصَل قرارُ التقسيم.
طُرحت أفكارٌ مختلفةٌ حول الظروف التي تحوّلت فيها الفيزياء النظرية أوائل القرن الماضي لصنعةٍ يهوديّة، ومهما كان السبب الحقيقي فقد لعبت هذه الصبغة الإثنية لفيزياء النواة دوراً سياسياً مع الوقت. بمعنىً ما، يمكن القول إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي بدأ مشروعها النوويّ قبل تأسيسها، فنخبتُها العلمية -التي هاجرت إليها أو ساعدتها عن بعد- كانت منخرطةً في المسألة النوويّة وتملك خبرةً فيها. بل وأكثر من ذلك، فمعهد وايزمان للعلوم الذي لعب دوراً مفصلياً في مجهود "إسرائيل" النوويّ كان قد تأسس في مستعمرةٍ غربيّ اللدّ عام 1934 أي قبل النكبة بـ14عاماً.2كان المعهد وقت تأسيسه يحمل اسم "معهد ديفيد سيف"، وتم تغيير الاسم بعد قيام "إسرائيل".
في هذا المعهد بالذات، ظهر المؤشر الأول على مجهودٍ بحثيّ للتلاعب بنواة الذرّة عندما أُسّس فيه قسمٌ لدراسة النظائر الكيميائيّة، يشمل مختبراً مختصاً بفيزياء النواة، وذلك عام 1949. وابتَعَثت "إسرائيل" في العام نفسه –وبتوجيهٍ شخصيٍّ من بن غوريون- 6 طلاب لاستكمال دراستهم في المجال النوويّ.3فؤاد جابر، الأسلحة النوويّة واستراتيجية "إسرائيل"، ترجمة زهدي جار الله، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1971)، ص23. يمثل كتاب جابر بالمناسبة مؤشراً مهماً على مستوى المعرفة (والجهل) بالمشروع الإسرائيلي أوائل السبعينات. وجابر كان طالب دراسات عليا مصري في الولايات المتحدة عندما أنجز عمله المرجعي هذا.

لكن قبل التأمل في مسار "إسرائيل" صوب قنبلتها الأولى، ينبغي التنبه لمزلقٍ كامنٍ في الكتابة عن هذا الموضوع، ذلك أنَّ فصولاً مهمةً فيما جرى ويجري بهذا الملف قد تكون حتى يومنا هذا خارجَ أيِّ معرفةٍ متداولة. وأقصى ما يمكن للمرء أن يطلبه هو تلمّسُ أكثر التسريبات إقناعاً، وألا يفترض أنّها سقف الحكاية الأعلى أو يجزم بصوابها. هذا الوعي بخصوصية الموضوع وحدودِ المعرفة الممكنة هو بوابةٌ إلزاميةٌ لمتاهةٍ مُعتمة كهذه. وربما نحتاج في دراسة "إسرائيل" ذريّاً ما نحتاجه في دراسة الذرة نفسها: تنحية اليقين جانباً، والاعتماد على علم الاحتمال سبيلاً للفهم.
الخمسينات: رهان فرنسا
من نافلة القول إنّ مشروعاً هائلاً كهذا يحتاج قاعدةً حديديّةً من العمل المؤسسيّ وتعاوناً بين آلاف البشر. لكنَّ قاعدة القاعدة في سرٍّ كهذا لم تكن مسألة مؤسسات، بل تقاطعاً لإرادات فرديّة. المثلث الذي قام عليه المشروع كان متركزاً في 3 أسماء؛ بن غوريون (قيادياً) وبيريز (دبلوماسياً)، وإرنست بيرغمان (علمياً).4كان بيرغمان كيميائياً ألمانياً عمل مع وايزمان لفترة قصيرة قبل أن يهاجر لفلسطين خلال موجات الاستيطان عام 1934، ويصبح لاحقاً رئيس الهيئة الذرية لـ"إسرائيل". ويبدو أنَّ توتراً مبكراً طبع بدايات المشروع بين بيريز وبيرغمان، وعلى نحوٍ رمزيّ لعلاقة السياسي بالعالِم؛ الأول أراد تسريع العملية باستقدام حلٍّ من الخارج، والثاني كان يريد اعتماداً أكبر على الذات ومشروعاً نوويّاً يبنيه بنفسه.
عام 1953، أعلن الأميركيون مبادرةً لتعميم الطاقة النوويّة حول العالم وأَشهروها تحت عنوان أميركي بامتياز: "ذرات من أجل السلام". انخرطت "إسرائيل" بالمبادرة على الفور وحصلت بفضلها على مفاعلٍ صغير بعد بضع سنوات5جابر، ص33-38.، لكن رهانَها الحقيقي كان مُعلّقاً في مكانٍ آخر. كانت رؤية شمعون بيريز أنَّ باريس، وليس واشنطن، هي فرس "إسرائيل" الرابح في سباقها النووي، وأنّ مزيج المعرفة التقنية الفرنسية والفوضى البيروقراطية التي تطبع بعض مؤسساتها بعد الحرب العالمية يفتح شقاً يسمح باقتناص شيء لن يمنحه الأميركيون بالغالب.
لعبت دولة الاحتلال حينها على جبهتين؛ الأولى هندسيّة، فقد طوّرت تقنيةً لاستخلاص اليورانيوم من الفوسفات، وادّعت ابتكارها آليةً رخيصةً لإنتاج الماء الثقيل6يتشكل الماء من عنصرين: الأكسجين والهيدروجين. لكن العنصر الثاني يحضر في الطبيعة على هيئة نظيرين مختلفين، وعليه فهناك ماءان في العالم: الماء الخفيف، والماء الثقيل، وذلك بحسب نظير الهيدروجين الحاضر فيهما. يُستخدم الماء الثقيل في المفاعلات العاملة على اليورانيوم الخام (غير المخصّب) لسبب مركزي: أنه أقل امتصاصاً للنيوترونات من الماء الخفيف، ويَسمح بذلك لسلسلة الانشطار النووي في المفاعل أن تصل للوتيرة المطلوبة. لا يحضر الماء الثقيل في الطبيعة إلا بنزرٍ يسير جداً: بين كل 20 مليون جزيء من الماء العادي، هناك جزيء واحد فقط من الماء الثقيل.، ثم تمكّنت من بيع "الفكرتين" لفرنسا بوقتها. ورغم أنّ التقنيتين لم تَثبت لهما جدوى وذهبتا أدراج الرياح، إلا أنَّ ما حصل أمّن لـ"إسرائيل" مكانةً بوصفها شريكاً علميّاً في المسائل النوويّة.7Avner Cohen, Israel and the Bomb, (New York: Columbia University Press, 1988 pp. 31-33.)
الجبهة الثانية كانت أمنيّة، فصعوبات الفرنسيين في الجزائر منحت دولة الاحتلال فرصةً لعرض خدماتها وتمتين مكانتها لديهم. كان تعداد اليهود الجزائريين يقارب المائة ألف بوقتها، وقدّمت "إسرائيل" عبرهم خدماتٍ استخباريّةً لفرنسا، عدا عن معلومات كانت "إسرائيل" تُقدّمها عن الدور المصريّ في مساندة الثورة الجزائريّة.
لكن اللحظة الذهبية أتت عام 1956 عندما أمّمت مصر قناة السويس، واقترحت فرنسا على "إسرائيل" هجوماً ثلاثياً للإطاحة بعبد الناصر وإفشال التأميم. في الاجتماع السريّ الذي عقده الثلاثة (فرنسا وبريطانيا و"إسرائيل")، لم يحاول بيريز أن يكون مرهفاً في ربط المسألتين ببعض؛ "إسرائيل" ستشارك لقاء ثمنٍ واضح: مفاعل فرنسي في النقب يعمل باليورانيوم الطبيعي (غير المخصب)، وهو ما سيُعرف بمفاعل ديمونا. 8Shimon Peres, Battling for Peace: A Memoir (London: Weidenfeld and Nicolson, 1995), p. 130. وفعلاً، حصل بيريز على ما يريد مع تعهدٍ بتزويد "إسرائيل" بالوقود النوويّ اللازم لتشغيل المفاعل. هذه صفقةٌ مدهشةٌ لأن "إسرائيل" كُوفئت فيها لا على تضحية تُقدِّمها وإنّما على هجومٍ تشنه ضدَّ ألدّ أعدائها.

لكن العدوان الثلاثي تعثّر بالإنذار السوفيتي الشهير، واضطرت دولة الاحتلال (ومن معها) للانسحاب. ومرةً أخرى، تحوّل الحدث دافعاً إضافياً في المشروع النوويّ لـ"إسرائيل"؛ ها هو فارق القوّة الذريّة يُجبر "إسرائيل" على الانصياع لدولةٍ بعيدة، وهذا بذاته أعطى مشروعها السريّ دافعاً معنوياً جديداً. ومن المفيد أن يتتبع المرءُ حرصَ "إسرائيل" على إطالة يدها النووية لتشمل دولاً تتجاوز العالم العربيّ بكثير، فوصول المدى الذريّ الإسرائيلي لقلب الاتحاد السوفيتي كان جوهريّاً للمشروع.
لكن الأهمّ هو تمتين الدعم الفرنسي، وإشعار الفرنسيين بأنّهم ورطوا "إسرائيل" في مغامرةٍ مُهينة في سيناء وأنَّ تعويضاً ما صار مستحقاً. هكذا، تطوّر المخطط الفرنسي لمفاعل ديمونا، ودخل عنصرٌ جديد، هو الأشدّ سريّةً على الإطلاق: معمل لاستخلاص البلوتونيوم من ست طبقاتٍ كاملة جميعها مطمورٌ تحت الأرض. هذا المعمل المدفون هو التتمة المُدَمِرَة للمفاعل الظاهر، فالوقود النوويّ الذي "يستهلكه" المفاعل ليس مجرد نفايات مشعّة. داخل الوقود الهالك ترقد نسب محدودة جداً من البلوتونيوم تشكّلت بفضل انشطارات اليورانيوم خلال عمل المفاعل "السلمي". استخلاص هذا المعدن الأثير كان سدرة المنتهى في كل ما يحصل. وهذا كان جوهر اللعبة: أن تتظاهر على السطح بأنك تستخدم يورانيوم (منخفض التخصيب) كي تولد به كهرباءً، فيما هدفك الفعلي هو أن تأخذ مخلّفات العملية تحت الأرض وتجتثّ البلوتونيوم لتصنع منه أعتى سلاحٍ ممكن. بقي هذا السرداب الكيميائي الهائل (المخصص لاستخلاص البلوتونيوم) سرَّ ديمونا الأهم لسنوات طويلة.
وُقِّعت الاتفاقية بين فرنسا ودولة الاحتلال لبناء مفاعل ديمونا في تشرين الأول/ أكتوبر 1957، ورغم أنَّ بنودها لا تزال سريّةً لليوم، فالقناعة الغالبة هي أنَّ سعة المفاعل الموعود ناهزت ـ24 ميغاواط. لكن طموح "إسرائيل" النووي كان أكبر من ذلك، وفي 1959، اشترى الإسرائيليون 20 طناً من الماء الثقيل بالاتفاق مع النرويج، وهي كمية تفوق كثيراً ما يحتاجه مفاعلٌ يعمل بالسعة المذكورة.9Cohen, pp. 61-62. كان هذا مؤشراً باكراً أنّ "إسرائيل" تُفكِرُ بشيء يفوق عرض الفرنسيين، وأنها عقَدت النية لتصعيد قدرة المفاعل حتى قبل اكتماله.

الستينات: عشريّة البناء والتضليل
عام 1960، باتت قبّة ديمونا ظاهرة من بعض شوارع النقب، ولم يعد ممكناً كتمان الأمر بالكامل. وتسرّبت حينها معلومات للصحافة حيال المشروع الإسرائيلي، وظهر تحقيق عن ديمونا في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام في صحيفة أميركية، وانفتحت بذلك العين الدولية على المشروع.
بعد ظهور التحقيق ببضعة أيام، هدّد عبد الناصر بحربٍ استباقيّة إذا ثبت أنّ "إسرائيل" تسعى لسلاحٍ نوويّ (23 ديسمبر 1960). وانطلق تحرك أميركي-فرنسي لتهدئة المصريين. تزامن هذا الحدث مع وصول كينيدي وديغول لسدة الرئاسة في بلديهما، وبدا أنّ كليهما يرغب بتقييد الاندفاع الإسرائيلي في ديمونا.
لكنّ تعطش "إسرائيل" للقنبلة كان أكبر من تحرّزات حلفائها، وفرّغ الإسرائيليون كلَّ إجراء اتُّخِذ لكبحهم من أي مضمون: ديغول أمر بإيقاف عمل حكومته على معمل ديمونا السريّ، لكن الأمر تحول سريعاً للعبة بيروقراطية، فانتقل العمل من مظلة الحكومة الفرنسيّة إلى مظلة شركةٍ خاصة، واستمر البناء وكأن شيئاً لم يكن. كينيدي طلب إذناً بجولات تفتيشٍ دوريّة للمفاعل10Cohen, p. 100.، لكنَّ "إسرائيل" غيّرت الأمر إلى "زياراتٍ علميّة"، وبمسارٍ وموعدٍ مُحدد سلفاً، وبوتيرةٍ لا تتجاوز الزيارة الواحدة سنويّاً.
كما رتّب مهندسو ديمونا آلياتِ تضليلٍ واسعة كي لا يَعرف الزائرون الأميركيون شيئاً مما يحصل أسفل أقدامهم، فأهمّ ما في المفاعل ظلّ سرّاً على الجميع. بُنيت غرفةُ تحكمٍ وهميّة بمؤشراتٍ مزيفة وشاشات رصد مخادعة هدفها حجب قدرة المفاعل الفعلية. كان المعنى البسيط لهذه القدرة الأعلى أنَّ قَدَراً أكبر من البلوتونيوم يُنتج سنوياً، وأن الوقت اللازم لتجميع ما يلزم لبناء رأسٍ نوويّ أقلّ مما تخيل الجميع.
وسط كلِّ هذا كانت سياسة "إسرائيل" قائمةً على عبارةٍ يُكرِّرها كلُّ مسؤوليها في حضرة السؤال النوويّ: "إسرائيل لن تكون الأولى بإدخال السلاح النوويّ للشرق الأوسط". لكنّ العمق الفعلي لهذه الأكذوبة لا يظهر إلا بتصريح لوزير العمل الإسرائيلي عام 1965 عندما قدّم التتمة المحجوبة من التصريح التقليدي فقال: "لن تكون إسرائيل أول من يدخل السلاح النووي للشرق الأوسط، لكنها لن تكون الثانية أيضاً".11Israeli Nuclear Armament - Report of the Secretary General, UN General Assembly, 18 September 1981.

حتى اليوم، ليس من معرفة مؤكدة عن اللحظة التي جمّعت فيها "إسرائيل" رأسها النوويّ الأول. لكن واحداً من أهم من كتبوا في هذه المسألة، آفنر كوهين، يرى أنَّ كل ما يلزم كان جاهزاً قبل حرب حزيران 1967 ببضعة أسابيع. قد يكشف هذا زاويةَ فهمٍ محجوبة للهجوم الإسرائيلي بوقتها ويفسّر جزءاً من الثقة العالية بالنفس التي أهّلت "إسرائيل" لاجتياحٍ بهذا الاتساع والعمق.
لعل سمةً أساسيةً في مشروع "إسرائيل" النووي هي أنّها لم ترهن نفسها لجهةٍ واحدةٍ ولا لتقنية مفردة، وأنّها كانت تحتال على كلّ جبهةٍ يمكن تخيلها حتى تصل بالمشروع لغايته. عام 1968، أوقفت "إسرائيل" سفينةً محمّلة بمئتي طن من الكعكة الصفراء قبالة جزيرة كريت، ونقلت حمولتها بجنح الليل لسفينةٍ مجهولة وعادت بها لـ"إسرائيل". كانت عملية السطو البحريّ تتويجاً لخديعة مطولة أدارها الموساد الإسرائيلي، وأسس في أثنائها شركة نقلٍ وهمية لينقل عبر إحدى سفنها شحنة من اليورانيوم من شركةٍ بلجيكيّة لأخرى إيطاليّة. ولم تُعرف تفاصيل الخديعة البحرية إلا بعد سنوات عندما اعتُقل عميل الموساد، دان إرت، في النرويج واعترف بما جرى لليورانيوم البلجيكي.12Roger Mattson, Stealing the Atom Bomb: How Denial and Deception Armed Israel, 2016, p. 110. لم تكن هذه قرصنةً عادية، فغنيمتها وفّرت لديمونا وقوداً إشعاعياً لثماني سنوات تالية.
واستطاعت "إسرائيل" في الستينات أن تَربح نوويّاً بكل اتجاه يمكن تصوره واعتمدت مقايضة زائفة في كثير من تعاملاتها العسكرية: كي تكفّ عن سعيها لامتلاك سلاح غير-تقليدي، طلبت أقصى سلاح تقليدي ممكن. عام 1962، وافق كينيدي على صفقة بيع صواريخ هوك أرض-جو مقابل موافقة "إسرائيل" على تفتيش مفاعلها النووي (والتي حوّلتها لزيارات علمية كما ذُكر سابقاً). وكانت صفقة الحصول على طائرات F4 التي نالتها مثالاً آخر، فبعد أن شرط الرئيس جونسون أن تُوقع "إسرائيل" على اتفاقية حظر الانتشار النووي كي يقرّ الصفقة، أصرّت "إسرائيل" على الرفض، وعاد جونسون في آخر سنة بحكمه وأقرّ الصفقة دون الشرط المذكور.
مع وصول نيكسون وكيسنجر للبيت الأبيض عام 1969، انتهت الممانعة الأميركية للنووي الإسرائيلي وطويت صفحة "الزيارات العلمية" لمفاعل النقب13Hans M. Kristensen & Matt Korda (2022) Israeli nuclear weapons, 2021, Bulletin of the Atomic Scientists, 78:1, p. 40.، وبات واضحاً أنَّ الولايات المتحدة تريد توطيد القدرة النووية لحليفها المفضّل، فابتاعت "إسرائيل" في حينه عدداً كبيراً من مفاتيح الصعق السريعة- Krytrons اللازمة للرؤوس النووية، بالإضافة لحاسبات خارقة لمصلحة معهد وايزمان للعلوم والتي تُستخدم لمحاكاة الانشطارات النووية واندماجاتها، وتُعفي بذلك مستخدميها من التجارب الفعلية.14Seymour Hersh, The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy, (New York: Random House, 1991), pp.213-214.
السبعينات: من الفكرة إلى منصة الإطلاق
عام 1973، حصل الهجوم العربي المشترك على جبهتي سيناء والجولان، وبدا في أيام الحرب الأولى أنّ خطراً غير مسبوق يداهم "إسرائيل"، وأنَّ ساعة الصفر دقّت لــ"خيار شمشون" أو "الملاذ الأخير"، وهي التسميات المستخدمة لسلاح "إسرائيل" الذري. ويروي عددٌ من مؤرخي تلك الأحداث قصةً بتفاصيل متشابهة عن عودة موشيه ديان من جبهة الجولان ليجتمع بغولدا مائير ويخبرها أن "خراب الهيكل الثالث قد أوشك".15Hersh, p. 223. كانت تلك العبارة كلمة السر حتى يبدأ تجهيز الرؤوس النووية. ويروي محمد حسنين هيكل أن السوفييت أبلغوا اللواء محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة العمليات، أن "إسرائيل" جهّزت 3 رؤوس نووية للاستعمال.16Hersh, p.240. لكن التقديرات المتوفرة اليوم تشير أن "إسرائيل" كانت تملك ما لا يقل عن 20 رأس ذريّ في تلك المرحلة، مع الصواريخ القادرة على حملها.
يقوم الغموض الإسرائيلي تجاه المسألة النووية على أمرين: ألا تُشهَر القُدرة، وألا يُجرَّب السلاح. مسألة الإشهار فقدت أهميتها مع الوقت، فما تسكت "إسرائيل" عنه بات أكثر الحقائق ترسخاً في وعي العالم. لكن التجريب قضية أخرى. عدة أسباب تُعفي "إسرائيل" من الحاجة لتجربة نووية. أولها أن التطور الهائل في الحاسبات وقدرتها على محاكاة الحدث النووي توفر بديلاً عن التجربة الفيزيائية. وثانيها هو علاقة "إسرائيل" بكثير من العاملين اليهود في مجال السلاح النووي حول العالم وهو يوفر لها مرجعيات تقنية لتقييم ما لديها دون حاجة للتجريب. وثالث الأسباب تتعلق بالقنبلة نفسها، فالأمر –لمن يعرف تقنياته- لا يحمل هامشاً واسعاً للخطأ، ويكفي أن نعرف أن أول تجربة نووية في العالم كانت تجربة ناجحة، وهذا يحمل دلالةً بذاته حول موثوقية التقنية. هذه التجربة أُجريت في الولايات المتحدة عام 1945، وكانت القنبلة المستخدمة فيها تحمل قالباً من البلوتونيوم. لكن حتى عندما قرر الأميركيون تدمير هيروشيما، فقد استخدموا قنبلة يورانيوم، دون أن يكونوا جربوا قنبلة كهذه من قبل. ومرة أخرى، "نجح" السلاح في تجربته الأولى.
لهذه الأسباب مجتمعة، فليست "إسرائيل" محتاجة أن تجرّب شيئاً من ترسانتها. لكن ذلك كله لم يكن كافياً لها، وأجرت –فيما يُعتقد- تجربة نووية (بالتعاون مع نظام الأبرتهايد في بريتوريا - جنوب أفريقيا) عام 1979.17Nic von Wielligh & Lydia von Wielligh, The Bomb: South Africa's Nuclear Weapons Programme, (Litera Publications, 2016), p.151. حصل التفجير في منطقة بحرية تتوسط المسافة بين جنوب إفريقيا والقارة المتجمدة، والتَقطت إحدى الأقمار الصناعية الأميركية ومضةً شديدةً في تلك اللحظة، ليكون ذلك الشاهد الوحيد على ما جرى.18تُعرف هذه الواقعة بحادثة فيلا (Vela Incident) نسبةً للقمر الصناعي الذي التقط ومضة الانفجار. ولا يحتاج الأمر خيالاً جامحاً لتقدير أن تجارب عديدة قد تكون أُجريت سرّاً دون أن يتسرب خبر عنها، أو أنَّ دولاً حليفةً لـ"إسرائيل" تكفّلت بإجرائها بالنيابة. خلاصة الأمر أنَّ ما يُدعى "سياسة الغموض" في وصف موقف "إسرائيل" من مشروعها الذرّي بات مسمّى أجوفاً لحقيقةٍ مؤكدة، وهو أنّ "إسرائيل" تملك ترسانةً نوويّةً كبرى.


صور فعنونو
كل ما طُرح من تخمينات حول المقدرة النووية الإسرائيلية تأكدّ تواضعُه أمام حقيقة ما يجري أسفل المفاعل. أكبر انكشاف كان عام 1986 عندما هرّب موردخاي فعنونو Mordechai Vanunu، الموظف الفنّي في ديمونا، آلةَ تصوير إلى داخل معمل استخلاص البلوتونيوم ونجح باقتناص 57 صورة مختلفة، بعضها شمل نماذج مصغرة لقنابل ورؤوس حربية. وقد حلّلت عدة جهات أميركية مجمل تلك الصور ووصلت لقناعة بأن "إسرائيل" باتت قادرةً على إنتاج قنبلة نيوترونية، وهي قنبلة إشعاعية بالمقام الأول، تُبيد الأفراد دون أن تدمر المنشآت والآليات.19Hersh, p.199.
نقل فعنونو كنزَهُ الاستخباري لصحيفة التايمز البريطانية، وبهذا، أُزيل قدرٌ من الغموض حول ما كان يجري في ديمونا (وتحته)، وصار واضحاً أنّ "إسرائيل" دخلت مضمار القنابل الهيدروجينية أيضاً. وأكثر من ذلك، فقد اتضح أن "إسرائيل" لم ترهن نفسها تقنياً للبلوتونيوم وحده، فقد كشف فعنونو أن إحدى مباني ديمونا مخصّصة لتخصيب اليورانيوم باستخدام الليزر، وهي تقنية غير شائعة عالمياً وكان يُظن أن "إسرائيل" لا تتعامل معها إلا بحثياً على نطاق ضيق.

وسائط القنبلة
تزامن عمل دولة الاحتلال على تطوير سلاحها النووي مع تأمين اللوجستيات اللازمة لرميه. وتتوفر مؤشرات أنّ "إسرائيل" ابتاعت وطوّرت قدراتٍ شتى بهذا المضمار:20خليل الشقاقي، الردع النووي في الشرق الأوسط، (الناشر للطباعة والنشر، 1990)، ص19-21.
- صاروخيّاً: منذ الستينات، عقدت دولة الاحتلال صفقةً مع شركة داسو Dassault الفرنسية لتطوير صواريخ طويلة المدى، والتي تُعرف إسرائيلياً بصواريخ أريحا. ومنذ جيلها الأول (أريحا-1) كان الصاروخ مُعدّاً لحمل رؤوس نووية. اليوم، ومع الجيل الثالث لصاروخ أريحا، تتراوح تقديرات المدى الأقصى للصاروخ (الذي يُحاط بالسرية) بين 5000 و11000 كم. وتُخبّأ بعض هذه الصواريخ في كهوف تحت الأرض في مستوطنة "زخاريا" (المقامة على أراضي قرية زكريا -25 كم شمال غربي الخليل) على نحو يُفترض أن يحميها من ضربة نوويّة معادية.
- مدفعيّاً: زوّد الأميركيون دولة الاحتلال منذ السبعينات بمدافع من عيار 175مم و203مم صالحة لإطلاق قذائف برؤوس نووية لمدى يبلغ 40كم، ويُعتقد أنّ الإسرائيليين جرّبوا مدفعاً مُركّباً عبر دمج سبطانتين من مدافع سابقة لتحقيق مدى يبلغ 70كم.21Hersch, p. 216.
- جويّاً: يُعتقد أنَّ السرب الموكل بالقصف النووي في حال إقراره يتشكل من طائرات F16 و F15 في قاعدة تل نوف (واحدة من أبرز 3 قواعد عسكرية جوية لجيش الاحتلال، تقع جنوب تل أبيب، بالقرب من مستوطنة رحوفوت).
- بحريّاً: تمتلك دولة الاحتلال خمس غواصات ألمانية على الأقلّ من طراز "دلفين"، اثنتان منها تحمل سبطانات بأقطار تتجاوز المألوف (650مم)، ويرجِّح مهتمون بالشأن العسكري أن قطراً كهذا تُمليه غايةٌ نووية. وأوردت دير شبيغل تقريراً عام 2012 يقول بأن الحكومة الألمانية على معرفة تامة بأن "إسرائيل" تنوي تسليح غواصات دلفين-2 برؤوس ذرية.22Hans Kristensen & Matt Korda, Israeli Nuclear Weapons, 2021, Bulletin of the Atomic Scientists, 78:1, 38-50.
- يدويّاً: يروي سيمون هيرش أنّ "إسرائيل" مرّرت للجانب السوفييتي أوائل السبعينات أنها طوّرت حقيبةً نووية؛ أي قنبلة ذرية تتسع لها جعبة يدوية ويمكن نقلها فرديّاً.23Hersch, p. 220. ولا يتوفر دليلٌ على هذا الجانب سوى الروايات الشفهية التي ينقلها صحفيون عن مصادر أمنية.

نماذج للقالب المتفجر (صور من داخل ديمونا / مجموعة موردخاي فعنونو).
هامش أخير
خلْف إدارة "إسرائيل" لسرّها النووي وصولاً لامتلاكها ترسانةً ذريةً كبرى، يقف أمرٌ لا يتعلق بالبراعة وحسن التدبير. ذلك أن أياً من القوى الكبرى لم تُعرِّض "إسرائيل" لتحدٍّ جدّي واحد في ملفها النووي. كانت القيادات الإسرائيلية تدير خداعها أمام حلفاء لا أمام خصوم، وكان في المحاولة الأميركية لكبح "إسرائيل" شيءٌ من الهزلية الأُسَرية لأبٍ يعاتب طفلَه بكلامٍ ناعمٍ لأنه سعيدٌ -سرّاً- بشقاوة الصبيّ.
كان هاجس "إسرائيل" الوجودي منذ نشأتها هاجساً عددياً بالنظر لمحيطها العربي. وكان مشروع القنبلة تتويجاً لحلّ هذا الهاجس وقهراً بالفيزياء لمشكلةٍ ديمغرافية مزمنة. ولا يبدو أنَّ كثيرين درسوا ما فعله ديمونا بالعالم العربي وصراعه مع "إسرائيل". إنَّ مزيج القوة الهائلة لهذا السلاح مع الصمت المطبق حياله يُحوّله من عاملٍ عسكريٍّ حاضر إلى أثرٍ خفي يَغشى الواقع ويشدّ أحداثَه موارَبةً. والثانية حتماً أخطر من الأولى بكثير.
تُقلِّبُ فيما تسرّبَ -وسُرِّب- عن سيرة "إسرائيل" الذرية، فيُدهشك شيءٌ أكثر من السلاح نفسه: أنّ خصم "إسرائيل" الأول وهدفَ رؤوسها النووية لم يُسهم في هذا الجهد الاستخباري بشيء، فنحن نَدين لحلفاء الكيان ولموظفٍ إسرائيليٍّ واحد في المفاعل بكلّ ما نعرفه لليوم عن هذا الملف. إنّ الإهمال العربي لديمونا -منذ انكشافه- والفشلَ بإيقاف القنبلة قبل اكتمالها لم يكن قصوراً عسكريّاً فحسب، بل فشلاً وجوديّاً لا يُغتفر.