يخيفنا الفيروس، يخيف العالم عموماً، فما بالكم بنا نحن؟ نحن الذين ليس لدينا نظام صحيّ يمكن الوثوق به والاطمئنان إليه. وهو تماماً ما فتح الباب للتندّر، ولاحقاً للإشاعات، بل ولحملاتٍ من النخوات المحليّة لمساندة المصابين، أو العصاب المحليّ كما حدث في منع نقل المصابين إلى بعض المحافظات.
الحقيقة النفسيّة التي تحكمنا أمام الكوارث الطبيعيّة، هي أننا لا نثق بقدرة أجهزتنا الحكوميّة على التعامل معها، وهذا ما يجعل خوفنا الطبيعي ينتقل لمراحل غير طبيعية في التعبير عن نفسه.
وفي لغة الأرقام، سنجد في موازنات الحكومة الفلسطينيّة ما يجعلنا نؤكد هذا القلق. إنّ أولويات هذه الحكومة وميزانياتها بعيدةٌ كلّ البعد عن الاستثمار في تطوير أجهزتنا الحيويّة الأساسية لوجودنا كمجتمع؛ الصّحة والتعليم والزراعة. عام 2018، شكّلت حصةُ قطاع الصّحة في ميزانية الحكومة ما يقارب الـ10%، فيما تجاوزت حصةُ قطاع الأمن الـ22% من الميزانية الحكوميّة.
ودون النظر إلى الميزانيات، يعرفُ الناس أنّ لدينا وزارة صحة ضعيفة جداً، يعرفون ذلك قبل الفيروس، من نوع العلاج الذي يتلقونه، ومن اضطرارهم الدائم للانتظار من أجل الحصول على تحويلة طبيّة، ومن ثم تصريح علاج إلى "إسرائيل". عام 2018، وصل عدد التحويلات الطبيّة إلى ما يقارب 100 ألف تحويلة. وهي تحويلات تهدف في أحيانٍ كثيرة لإجراء فحوصات وعلاجات من الحد الأدنى من متطلّبات العناية الصحيّة، كغسيل الكلى مثلاً. وقبل غزو الكورونا بيومين كان الأطباء الفلسطينيّون يخوضون إضراباً لتحسين ظروف عملهم، في تعبير عن جزءٍ من البؤس الذي يشهده قطاعنا الصحيّ.
ارتباك الجهاز الصحي
ورغم أنّ وزارة الصّحة ومعها رئيس الحكومة الفلسطينيّة كرروا مراراً أنّهم في "كامل الجهوزيّة والاستعداد" للتعامل مع فيروس "كورونا" في حال ظهر عندنا، إلا أن ما شهدناه منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، وبعد الإعلان عن الإصابات الأولى الخميس الماضي هو الارتباك بعينه، لا الجهوزية.
في أريحا مثلاً، يفتقر المحجر الصحيّ المُخصص للعائدين من السّفر لأبسط معايير النظافة والرعاية الطبيّة. ورغم الجهوزية المفترضة، فقد أُعلن عن البدء بتخصيص وتجهيز مقرات للحجز الصحيّ والمتابعة للمصابين والمخالطين لهم فقط بعد يوم الخميس. وإذا أردنا أن نستذكر الواقع الأكثر قسوة، فيمكننا أن نسأل: لماذا لا توجد في مستشفياتنا المنتشرة في كلّ المحافظات أقسام خاصّة ومخصصة لحالات العزل، حتى نحتاج إلى تخصيص مبانٍ منفصلة للحجز؟ يُضاف إلى ذلك سؤال: ماذا عن التجهيزات والآلات الطبيّة التي ستزوّد بها هذه المراكز، والطواقم الطبيّة؟
الإجابة الوحيدة التي شهدناها من السلطة: قوّات أمنيّة على مداخل مراكز الحجز أكثر بكثير من عدد الطواقم الطبيّة؛ طبيبان فقط في مركزٍ يُحتجز فيه العشرات، بينما يطوّقه العشرات من رجال الأمن!
ظهر الارتباك كذلك في الأداء الإعلاميّ لوزارة الصحة. بدلاً من أن تُرمم الوزارة علاقتها مع الناس، ذهب الناطق باسمها إلى التعبير عن رغبته بـ"إبداء ملاحظات على المواطن الفلسطيني"، وبدلاً من طمأنتهم حول التجهيزات الجادّة لمكافحة الفيروس، أرشد المحتجزين في حجز أريحا إلى تنظيف غرفهم بأنفسهم من الغبرة! (حذف المنشورين لاحقاً).

وفيما قررت الحكومة أن تحصر التصريح الإعلاميّ بمكتب رئيس الحكومة، لا بمختصين من الجهاز الطبيّ، فإن تصريحاتها اليوميّة عن الإصابات الجديدة لم تكن مترافقة مع معلومات كافية وواضحة عن حركة أصحاب تلك الإصابات وسيرهم خلال الأيام الماضية. أدّى هذا الارتباك إلى نقص في المعلومات التي تَـلزَم الناس شرّ العدوى، فبحثوا عنها في "فيسبوك"، وفي الإشاعات التي تكاثف اختلاقها ونشرها.
لكن الموضوع الأبرز والذي مرّ دون كثير التفات هو لماذا أُعلنت حالة الطوارئ فور اكتشاف 7 إصابات؟ هل بالفعل لا تمكننا مواجهة الفيروس دون إعلان الطوارئ؟
إعلان الطوارئ
وصلت الإصابات بفيروس الكورونا في دولٍ كثيرة أضعاف ما عندنا، ولم تُعلَن حالة الطوارئ بل كان من واجب الحكومات أن تحاول السيطرة على انتشار المرض، وأن تُطمئن الناس، لا أن تفزعهم من بداية الطريق. تحاول الدول في العادة تأجيل إعلان حالة الطوارئ ما استطاعت حتى لا تمسّ بحقوق وحريات الناس فوق المطلوب، وحتى لا تعطل البلد وتفزع الناس. في حالتنا بدأنا بإفزاع الناس ومن ثم التفكير بمواجهة انتشار المرض.
يقال لنا إنّ تلك دولٌ لها أجهزتها وقوّتها، أما نحن فإنّنا لا نُقارن بغيرنا من شدّة ضعفنا. تُريد السّلطةُ لنا إذاً أن ننطلقَ من حقيقةِ ضعفِها كمسألةٍ أساسيةٍ، ونتيجةً لهذا الإدراك أن نثق بها بشكلٍ أعمى في باقي الإجراءات! هذا هو ما بثّه النقاشُ حول إعلان حالة الطوارئ في نفوس الناس. مثلاً، لخصّ غسان الخطيب، وهو أكاديميٌّ وسياسيّ بارز، هذه الفكرة بكلماتٍ واضحة: "يلفت انتباهي الاستخفافُ والتشكيكُ بالتعليمات.. وكأن هذا امتداد لروح التمرد على السّلطات، مع العلم أنّ خلاصنا يكمن باحترام واتباع هذه التعليمات واحترامها وعدم مناقشتها وعدم التشكيك فيها".
لطالما استخدمت مختلفُ الأنظمة الإعلانَ عن حالة الطوارئ تحت مسوغات أمنيّة بهدف الإمعان في قمع الناس وتقييد حرياتهم. وبسبب تطرف هذه الأداة وتطويعها سياسيّاً في الغالبية الساحقة من الحالات، فإنّها عادةً ما تسترعي التفاتاً رقابيّاً من جهاتٍ مختلفة حقوقيّة وصحافيّة وغيرها، وعادةً ما يُواجهها الناسُ بمقاومةٍ أو على الأقل بتشكيك.
وفي الواقع، فإنّ الإعلان عن الطوارئ في ظروف صحيّة كهذه أخطر بكثير منها في ظروف أمنيّة، لأن أساس إعلانها قائمٌ على الفزع الصحيّ، وهو أمرٌ مجهولٌ تماماً بالنسبة للناس، ولأنّه يمسّ حياتهم بشكلٍ مباشر. وهو خطيرٌ لأنّه في ظروف كهذه يهيمن خطابُ "مش وقته"، ويُوضعُ حسن النوايا في غير موضعه، ويجري الالتفات على كلّ شيءٍ لصالح الخطر المحدق أمامهم. وهو خطاب من الممكن أن يفرّط في كل شيء يمسّ بكرامة الناس وحريتهم لصالح النجاة والخلاص العينيّ من المرض.
ويمكنُ القول إنّ السلطة لا تحتاج لقانون الطوارئ حتى تنتهك ما تريد من القوانين وتداهم وتعتقل. هذا صحيح، لكن الفارق عن الأيام العادية، أو حتى عن الطوارىء ذات المسوغات الأمنيّة، أن الطوارئ في حالات الصّحة ستُلاقي قطاعاتٍ شعبيةً واسعةً تؤيدها، وستشهد غيابَ كثيرٍ من منظومات الرقابة المجتمعيّة، لأنّها لن تجرؤ في ظلّ انتشار السعار والقلق أن تُـنَـبِّه لتقصيرٍ هنا وتجاوز هناك. هذا هو جوهر خطورة هذه الحالة، أنّها ستعمّ ضمن إرادة جماهيريّة قائمة على الخوف مما هو "أكبر".
وفي هذا السياق جاء بيان نقابة الصحافيين ليحذر الصحافيين ويخوفهم من أن "إعلان حالة الطوارئ يضعهم على المحك...وذلك لتجنب الملاحقات الأمنية التي فتحتها حالة الطوارئ.. ودعت الصحفيين إلى التفاعل الإيجابي مع المؤسسة الرسمية ..". ومع أهمية التنبيه للتأكد من المعلومات وعدم نشر الإشاعات الذي أشار له البيان، إلا أن أهمية الصحافة في ظروفٍ كهذه تنبع من دورها المنشود في كشف التقصير الذي يظهر في القطاع الصحيّ حتى لا تنبني عليه خسائر في الأرواح، والتركيزِ مع أي تجاوز تمارسه السلطةُ التنفيذية في هذه الظروف ولا يندرج ضمن محاربة انتشار المرض، وهو ما فات النقابة تنبيه الصحافيين منه.
ولأنّ الأمر كذلك علينا أن نرفع من يقظتنا وحذرنا تجاه السّلطة الفلسطينيّة التي أعلنت الطوارئ، وأن نطالب باستمرار تفسيرَ كلِّ خطوة، فعلى كلِّ خطوةٍ تتخذُها الحكومةُ أن تكون مبررةً تماماً بالعلاقة بمسألة مواجهة الفيروس، والحاجة إليها في هذا الإطار وحده. كما على الخطوات أن تكون نابعةً من تقدير أهل الاختصاص، وأن تُفسّر بشكلٍ مستمرٍ وبشفافية للناس. وفي هذه السّياق لم يفسر لنا أحدٌ حتى الآن وبناءً على أسباب طبيّة، ما هي الحاجة الفعليّة لإعلان الطوارئ بدل اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية عينيّة؟ وفي حال كانت حالة الطوارئ مبررة من منظور طبيّ، ما الحاجة لبعض الإجراءات ضمنها؟
ما الحاجة مثلاً لإدراج منع "الإضرابات" في قائمة الخطوات المتبعة لمواجهة الفيروس؟ وما سبب إصدار وزارة التربية والتعليم لبيان، ورد فيه بند يمنع العاملين فيها من "نشر تعليقات سلبيّة" حول إعلان حالة الطوارئ؟ وما الحاجة الفعلية لنشر رجال الأمن مجهزين وملثمين في الشوارع وعلى مداخل جميع المدن؟ هل هناك قرار باغلاق المدن أم باستعراض الهيبة؟
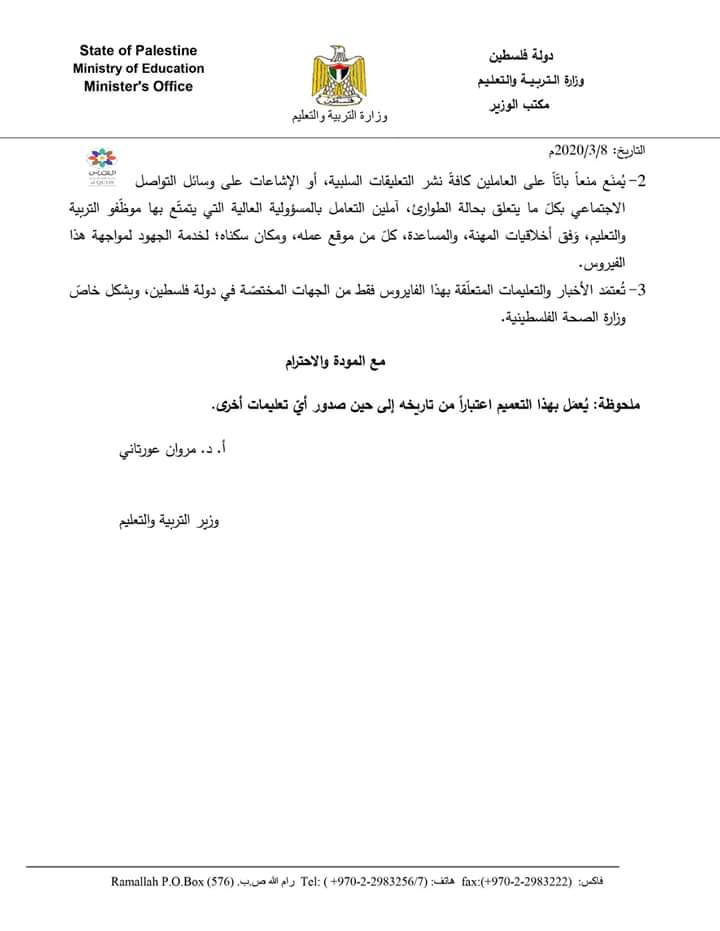
يتصدر رجالُ الأمن اليوم صور حالة الطوارئ لمواجهة فيروس، وكأن السلطة تعيد تصدير صورتها وهيبتها المفقودة، فيما لا يتصدر الاطباءُ والجهاز الطبيّ المشهد. إنّ محاولة تعزيز الثقة الوحيدة التي أبدتها الحكومة كانت أمنيّة، وهو آخر ما نحتاجه لمواجهة الفيروس. وهذا النوع من الإجراءات الأمنيّة مرشح للتوسع بشكلٍ تدريجيٍّ والتغول ليتجاوز حالته المخصوصة الصحية التي نمرّ بها، ليتحوّل إلى حقائق ثابتة يتم تجاهلها بذريعة الظرف العام الطارئ.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بياناً أكدّت فيه بأنه "لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ". وطالبت الحكومة "بالإعلان وبشكل مستمر عن التدابير المتخذة في سياق حالة الطوارئ أو اية تدابير خاصة أخرى من شأنها الحد من الحقوق والحريات".
انتقد البعضُ بيانَ الهيئة مستخدمين خطاب "مش وقته". يُظهر هذا الخطابُ بوضوح خطورة الوعي الذي من الممكن أن يترسخ في أذهان الناس في مثل هذه الحالات الحرجة. وهذا مثالٌ على تحوّل الفزع تدريجيّاً إلى خطاب يقمع كلّ جهة تسلّط الضوء على انحراف أو تغوّل تمارسه السلطة في حالة الطوارئ. بشكل فعلي نحن مدعوون للتسليم بعسكرة السلطة علينا، وبالفكرة النهائية منها وبأنها سيدة للأمن قبل الصحة، وأن صحتنا بالضرورة يجب أن تمر عبر خوفنا وليس حقّنا. إننا خائفون صحيح وهذا شرعي، لكن الذي لا ينبغي أن يكون شرعياً ويتعزز كأمرٍ واقع، هو أن تشتري السلطة منا خوفنا وتُـنميهِ لنا حتى نبقى مشدودين إليها، ومنقادين تماماً للسيطرة التامة علينا.
ذاكرتنا السيئة مع حالة الطوارئ
لدينا، نحن الفلسطينيين، ذاكرةٌ سيئةٌ مخصوصة مع حالة الطوارئ، فعدا عن إعلان الطوارئ من الاحتلال الإسرائيلي الذي نعيشه حتى اليوم، فقد أُعلن نظام الطوارئ في السّلطة الفلسطينيّة مرتين، وذلك في 2003 و2007. والأخيرة هذه خصوصاً ما زلنا نتذكرها على شكل ممارسات تعذيب واعتقال للمقاومين والمعارضين، وانتهاك حرمات بيوت الناس وإغلاق للجمعيات ونهب لأموالها.
وعلى هذه الذاكرة اليوم أن تجعلنا أكثر يقظة، خاصةً في ظلّ نظامٍ فلسطينيٍّ سياسيٍّ وصل إلى حالةٍ غير مسبوقة من السوء وغياب الرقابة، تطغى عليه صفة الفساد والجنوح الدائم نحو الطغيان علينا. وكذلك في ظلّ جهازٍ تنفيذيّ بدون رقابة عليه بعد تعطيل المجلس التشريعيّ في 2007، ومن ثمّ حلّه في ديسمبر/كانون الأول 2018، فمن يفرض الطوارئ اليوم هو من يتحكم بالأمن والصّحة كما يتحكم بالرقابة عليهما. وفيما الناس فزعة وتسيطر عليها فكرة "اتبعوا الخطّة، وتجمدوا بخوفكم"، فإنّ الصحافة والرقابة القانونيّة والحزبيّة والمهنيّة تتجمد أيضاً في مكانها فيبتلعنا نظامٌ أمنيٌّ بدون رقابة.
فور إعلان حالة الطوارئ تم اعتقال القيادي في "فتح" حسام خضر على خلفية انتقاده لتصريحات الرئيس ضدّ إضراب نقابة الأطباء. في اليوم ذاته، اختفت ميزانية وزارة الصحة عن موقعها الإلكترونيّ وكذلك عن موقع وزارة المالية والتخطيط، والحجة: "بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي"، هل لاحظ أحدٌ ذلك؟ وهل هذا وقت هذه الأسئلة التفصيلية؟ نعم هذا تحديداً هو الوقت، قبل أن يجري تثبيت حقائق بشكلٍ تدريجيٍّ على غفلة منا.
من المرجح أن يواصل هذا الوباء تقدمه لفترةٍ نسبيةٍ تبدو طويلة كما يذهب لذلك بعض الخبراء. في المقابل، فإنّ حالة الطوارئ التي ينصّ عليها القانون الأساسيّ الفلسطينيّ في المادة 110، تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعيّ لتمديدها لغرض الرقابة عليها. وفي غياب ذلك فإن الرئيس قادر على تجديدها تحت المادة الأولى من فزعنا، وهذا يعني أن تخضع الضفة الغربية لحالة طوارئ مستمرة من قبل السلطة الفلسطينيّة.1مواد الباب السابع المتعلق بإعلان حال الطوارئ، نصت المادة 110(1)، أن للرئيس الحق في إعلان حال الطوارئ عند "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية... لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً" على أنه يجوز له "تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بغالبية ثلثي أعضائه"، كما نصت على ذلك المادة 110.
في الختام، لا يمكن أن ننسى "إسرائيل" من كل هذا. بعد الإعلان الفلسطينيّ للطوارىء أعلن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت عن فرض إغلاق كاملٍ على منطقة بيت لحم. كما تناولت وسائل الإعلام احتمالية توسيع الإغلاق ليشمل كلّ الضفة الغربيّة، وذلك رغم تجاوز الحالات المعلنة في "إسرائيل" ضعف الحالات المعلنة في الضفة الغربية. وكذلك أعلن عن احتمالية السّماح للعمال الفلسطينيّين حاملي التصاريح بالمبيت في أراضي الـ48، حتى لا يؤدي إلى إغلاق شامل للضفة الغربية إلى مزيد من تدهور في قطاع البناء الإسرائيلي!
وفي ذات اليوم الذي أعلنت فيه السلطة الفلسطينية عن حالة الطوارئ، التقى ممثلو السلطة ممثلين إسرائيليين لتنسيق مواجهة الفيروس بين الطرفين. اللافت في هذا اللقاء حضور رئيس قسم مكافحة الإرهاب في المجلس القوميّ الإسرائيليّ. ووفق محلل إسرائيلي في "هآرتس" فإن الجانب الإيجابيّ الوحيد للكورونا هو الهدوء النسبي الذي يسود الجبهة الأمنيّة- وبالذات إقليمياً. يعني هذا أن استمرار هذه الحالة ستستثمره "إسرائيل" إلى أقصى حدّ في تعزيز هيمنتها وسطوتها. لكن هذه المرة من البوابة التي يسهل غض الطرف عنها وهي التنسيق الصحيّ، والذي في حالة عدو كـ"إسرائيل" لا يعود صحيّاً فقط.


