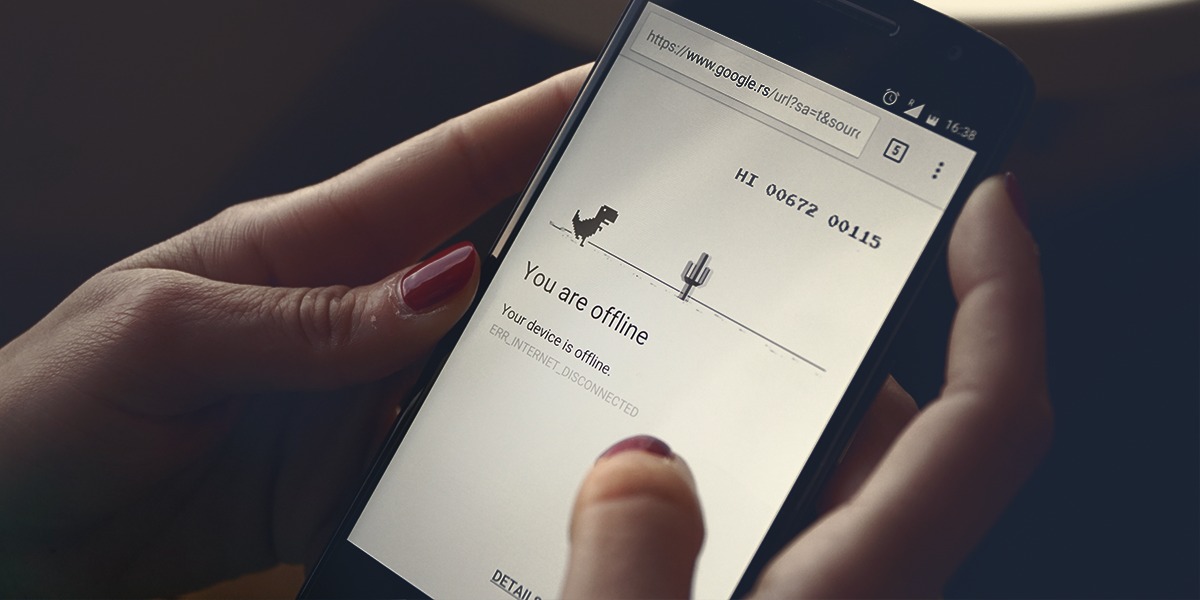حينَ تنوي تعطيلَ حسابك على "فيسبوك"، يعدِّد لكَ الموقعُ أسباباً محتملة لذلك، ويجبرك على اختيار واحدٍ منها. بعضُ تلك الأسباب منطقيّ، كأنْ يكونَ "فيسبوك" مضيعةً لوقتك، أو أنَّك لا تشعرُ بالأمان على هذه المنصَّة، لكنَّه يقدِّم لكَ حلّاً لأيٍّ من تلك المشاكل فورَ اختيارها. نصيحة، إنْ أردتَ أن تُعطِّل حسابك بسلامٍ، وبسرعة، أخبره أنَّك تمتلكُ حساباً آخر. حينها فقط سيقبلُ بالسببِ، دونَ عجَب.
أعرفُ هذا جيداً لأنّني أعطِّل حسابي مرَّاتٍ لا تُحصى، وكلّ مرَّة، يسألني الأصدقاء: "ليش اختفيتِ؟". آخرَ مرَّة عطَّلتُ فيها حسابي، اقترحَ عليَّ "فيسبوك" أنْ أقرِّرَ من الآن ما سيحصلُ بحسابي بعد وفاتي. ارتعبت. ليس من وفاتي المحتمَلة في أيِّ لحظة- ما يجعلُ "فيسبوك" مُحقّاً فعلاً- إنّما من أنْ يبقى كلّ ذلك ورائي كـ"العمل الرَّدي". كلّ الصور والتعليقات والرسائل وما شاركته على مدارِ 11 عاماً. ارتعبتُ من فكرةِ أنَّ ذلك موجودٌ حقاً الآن، وفي اللحظةِ التي سأضعفُ فيها وأعيد تفعيلَ حسابي، سيكون مكشوفاً للعالم.
من المفترض أن يعدّد هذا المقال إجاباتٍ- لا تُحصى- للسؤال: "لماذا عليَّ أنْ أهجرَ السوشال ميديا مرَّة واحدة، وإلى الأبد؟". أكتبه وأنا ضجرةً، بعد أنْ حذفتُ حسابي على "انستغرام"، وأزورُ "فيسبوك" مرَّة واحدة أسبوعيّاً كالـ"حرامية"، ولخمسِ دقائق فقط. أزوره تجنباً لتفويت معلومات ضروريَّة، تعينني على تحسّس طريقي في عالم الأوفلاين الموحش، فألقي نظرةً سريعةً على الأخبار التي "أشعلت" وسائلَ التواصل الاجتماعيّ، والقضايا الأحدث لكشف المتحرّشين من حوْلي، وعلى أخبارِ الخطوبة والزواج، أولاً بأوّل، ثم أعطّل الحسابَ مجدداً.
الفيَضان
تُنشرُ يوميّاً 500 ملايين تغريدة على تويتر، بينما يطالعُ 1.62 مليار مستخدمٍ موقعَ "فيسبوك" كلَّ يوم. تتركّز أعينهم على الشاشة، ويستهلكون بنهمٍ كلَّ ما يقعُ تحتَ أصابعهم لدقائق وساعات. لا يُعقَل أنْ تكون ملايين المنشورات تلك كلّها قيِّمة، فما نتذكّره حين نفرك أعيننا بعدَ "تفقّد" حساباتنا، بالكادِ يكفي لإلهامِ فكرةٍ واحدةٍ في هذا الرأس المُتعَب، من فرطِ ما أُلقيَ عليه من كتاباتٍ وصور وأصوات.
يصبحُ هذا "التفقّد" سلوكاً قهريّاً، وبمجردِ أن تفتح عينيْك تنهالُ عليكَ الرسائل وأفكار الآخرين كالصفعات على وجهك، متوقّعين منكَ أنْ تكونَ متاحاً لاستقبال هذا الفيضان من القلق في كلِّ حين. علاوةً على ذلك، تُصبحُ أنتَ أيضاً منشغلاً بِما ستشاركه معهم. تُطالِعُ خلالَ نصفِ ساعةٍ منشوراً لشريكيْن يعبّران عن حبّهما لبعضهما، وكأنَّ الرسائل الخاصة، أو المحادثات وجهاً لوجه قد اختفت عن وجه الخليقة. وبعدها تُعلِّق قريبةُ والدتك على صورتك، متمنيةً لكَ الزواج قريباً، وأنتَ لم ترَها منذ خمس سنوات. لم تكنْ مستعداً نفسيّاً لخبرٍ محزن عنْ قريبِ صديقٍ لا تعرفه، ولم تكن لتعرفَ بما حصل معه لو لم ترَ المنشور على "فيسبوك"، وذلك لأنّه في الحقيقةِ لا يخصّك، ولكن ها نحنُ الآن، فلتحزن. لن يطولَ الحزن لأنَّك تطالع "ميم" مضحكة- ذكوريَّة قليلاً، لكنْ مضحكة- نشرَها صديقٌ التقيتَ به في دورةٍ تدريبيَّة عام 2008، ولو رأيتَه في الطريقِ لما التفتَّ إلى الوراء، ولقلتَ ما قال المسافرُ للمسافرة الغريبِة: يا غريبة.
إلى جانبِ كلِّ ذلك الهراء، ومعه كل مقاطع الفيديو لوضع مساحيق التجميل، وتوقعات طلال أبو غزالة، وإعلانات جلبِ الحبيب، إنَّ لوسائل التواصل الاجتماعيّ طريقةً فريدةً في إفراغِ القضايا الجديَّة من معناها. لنأخذ خبراً مهمّاً- تكرّر للأسف مراراً- كمقتلِ امرأة مثلاً. أصبحنا نحفظُ نمطَ المنشورات عن ظهرِ قلب: ينشرُ أحدُ الصحافيِّين الخبر الأوليّ، كما نقله له جهازُ الشرطة طبعاً، وينسخه عنهُ زملاؤه في محضِ دقائق. حسناً، نعرفُ الآن أنَّ هناك فتاةً قد قُتِلت في ظروفٍ غامضة، ونعرفُ أين وُجدَت جثّتها.
تعِدُنا الشرطة بتحقيق، لن نرى نتائجه على أيِّ حال، فيجتهدُ مستخدمو "فيسبوك" في التحليل: انتحرت، لا؟ لا، تستحقُ القتل؟ ربّما. ثمَّ يحتارون في نشرِ صورةِ الضحيَّة بحجاب، أم دونه، فيقرّرون ألّا ينشروا صورَها أصلاً، باستثناء صورتها وهي جثَّة، والتي تكرَّم أحدهم بنشرِها أوَّل مرَّة. طيب، انتهيْنا من موضوع الصورة، فلنتفرَّغ للتعليقات، ستتداول بعضها الإشاعات حول الفتاةِ وعائلتها وسبب قتلها، وستهاجم بقيَّة التعليقات هؤلاء؛ المعلِّقين أعلاه، ونعود للنقاش الأوَّل منذ بدء الخليقة- للمرَّة الألف- حول تعريف الشرف.
للاستماع إلى المزيد من المقالات، يمكنكم الاشتراك في خدمة «صفحات صوت» إما من خلال الموقع أو تطبيق آبل بودكاست.
هذا فقط مثالٌ واحد، تلقى مصيرَه معظمُ القضايا المهمَّة، فيُنسى سريعاً ويضيع، قبلَ أنْ نعيَ خطورته وآثاره، ودون أنْ نفهم حقاً ماهيّته. مثله، تصبح القضايا السياسيَّة أيضاً مادةً سطحيَّةً للتسلية، ونتابعها إلى أنْ يطرأ حدثٌ أكثرَ إثارة، جديرٌ بأنْ يكونَ تسليةً جديدة. ثم إنّنا نستهلكُ يوميّاً أخباراً وتحليلاتٍ سياسيَّةً واجتماعيَّة يجتزئها أصحابُها في 200 كلمة، ولا يقدّمها من هم بالضرورة أشخاصٌ ذوو معرفةٍ حقيقيَّة، إنما اكتسبوا ثقةً تتراكم بحجمِ متابعتنا لهم. ويكرّس كثرٌ منهم صوراً نمطيَّة ومعلوماتٍ مغلوطةً دونَ رقيبٍ ولا حسيب، سوى قسمِ التعليقات، والذي غالباً ما يتحوّل إلى جبهةِ قتالٍ محتدمة.
هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم، وهكذا يتشكَّل- غالباً- الرأي العام اليوم، وحتى أحاديثنا في العمل وفي سيارات الأجرة، أغلبها تبدأ بعبارة: "شفتِ شو نزَّل عالفيسبوك؟". الأمرُ كذلك إن أحببنا، أم "انفلقنا".
مِنْ تَحته لكوعك، أطلعلك
بينما أكتبُ هذا المقال، عن هجرِ السوشال ميديا هرباً من الهُراء الذي أفنيتُ عُمري في متابعته، تشاهدُ عائلتي التلفاز. تلاحقنا "الفاشي- نيستاس" إلى عُقرِ دارنا. في كلّ حلقة من برنامج تحدي الفاشينيستا الذي يُعرض على قناةِ الـMBC، تدعو جويل مردينيان، خبيرة التجميل الأشهر، فتياتٍ يمتلكنَ عدداً لا بأس به من المتابعين على تطبيق "انستغرام"، ليخُضنَ مسابقةً في اختيارِ ملابس جديدة للمشتركين والمشتركات؛ هؤلاء الطامعين في تغيير "ستايلـهم". أشاهدهنّ وأنا أرتدي ملابسَ النوم وأحتسي شوربة العدَس مع فجلتيْن.
اقرؤوا أيضاً: "ناس ديلي".. دُمية جديدة لتلميع "إسرائيل"
جويل، التي يتابعُها أكثر من 15 مليون متابع على "انستغرام"، هي الأمّ الروحيَّة لكلّ هؤلاء الفاشينيستاس. منذ أكثر من عقدٍ، اشتُهرَ برنامجها على قناة الـMBC "بصراحة أحلى"، الذي تغيّر فيه مظهرَ فتياتٍ استنجدنَ بها ليكنّ "على الموضة"، ومن حينها وهي تعلِّمنا أنَّنا لسنا أحلى، بصراحة يعني. من حينها، أصبحت "ثقافة جويل" في كلِّ مكان، أي تنميط الجمال بشفاهٍ أكبر، ووجه بلا تجاعيد، وجسمٍ منحوت، وأظافر ملوّنة طويلة، وأسنان بيضاء كأنَّها لم تلامس كوبَ قهوة في حياتها.
استضافت حلقة "تحدي الفاشينيستاس" حلا ترك كمشاركة، وهي "إنفلونسر" أيضاً، عمرها 18عاماً، قد تتذكرونها حين كانت طفلةً بلا أسنان أماميَّة في برنامج "آرابز جوت تالنت" عام 2011. يتابعها الآن 5 ملايين شخصٍ على "انستغرام"، غالباً لمتابعةِ الأخبارِ "الساخنة" لعائلتها، بين انفصالِ والديْها، وتحريض زوجة أبيها، فالبيوت- كما تعرفون- أسرار. ليسَ هناكَ مفرٌّ سهلٌ من "مؤثري" السوشال ميديا، فتجدُنا "من تحت الدلف لتحت المزراب"، وتجدهم "مِن تحته لكوعك، أطلعلك"، ومن يهرب من مئاتِ "الميك-أب أرتيستس" على "انستغرام"، سيلاقيهنّ في التلفاز.
سيَغزو "الإنفلونسرز" من عارضات أزياء، ولاعبي كرة قدم، وفنانين صفحاتِ هواتفنا وعقولنا بنصائح لن نحتاجها، وسيخلقون لنا عالماً موازياً، ننشغلُ به بثرائهم، وحقائبهم، وملابسهم، والمنازل التي يسكنونها. كلّ ذلك بينما يزدهرُ عملهم بسبب زيادة متابعيهم، نحن، رأسمالهم والسلعة التي يبيعونها. من المتوقع أن تصبح صناعة التسويق عبر المؤثّرين بقيمة 15 مليار دولار خلال عاميْن، فسيزيدُ 63٪ من المُسوِّقين في العالم موازنات التعاقد مع هؤلاء المؤثرين في العام المقبل.
سواءَ كُنَّا نتابعُ معارفنا فقط، أم هؤلاء المشاهير عَن بُعد، نَجِد أنفسنا- لا شعوريّاً- نقارن حياتنا بحياتهم. إنَّ نموّ قاعدة متابعيهم يعتمدُ فعليّاً على إشعارِنا بالنقص، بأنّنا لسنا هُم، ولا نمتلك ما يمتلكونه من مالٍ، أو نجاحاتٍ، أو علاقات. هذا النقص الذي يخلقُ فينا نهماً لمتابعتهم أكثر، على فرضِ أنَّهم هم العالم؛ هم من يجبَ أن نُقارَن به. على بؤس هذا الاعتقاد، يسعى بعضُنا لتقليدِ هؤلاء، واستهلاكِ ما يروّجون له، لعلّنا نحصلُ على هذه الحياة الفاخرة المثاليَّة، التي لا نرى منها إلّا دقائق معدودة- مُمَسرحة- فقط.
أنا، ونفسي، وحضرة جنابي
هذا ليس ادعاءً شخصيّاً كَجُلِّ ما وردَ أعلاه: الإدمان على لوسائلَ التواصل الاجتماعيّ هو تعبيرٌ عنْ اضطرابٍ نفسيّ. يكمنُ السبب في طبيعة المنصّة ذاتها، لأنَّ مواقع التواصل تهدفُ بالأساس إلى الترويجِ للذات، فيربطُ الباحثون الإدمانَ على وسائل التواصل الاجتماعيّ بالنرجسيَّة، أو بتزعزع الثقةِ بالنفس، وبلسمُ الاضطرابيْن هذيْن هو المزيد من الاهتمام والتوكيد من الآخرين. نتعطّشُ لتقييمٍ مستمرّ من العالم؛ هذه صورتي وأنا أرتدي فستاناً، فقولوا لي إنّي جميلة، أمطِروني بالإطراءات.. انظروا، نجحتُ بالامتحان، حتى لو كان امتحاناً سخيفاً، تعالوا نحكي عنّي أنا، وأنا فقط، ركّزوا معي. عبقريَّة، ها؟
اقرؤوا أيضاً: بيع الذات في سوق "اللايكات".. عن مؤثّري الـ"سوشال ميديا"
تترافق هذه النرجسيَّة، التي تغذّيها السوشيال ميديا وتعتاشُ عليها، مع جعلِ كلّ موقفٍ منصبّاً حولنا. مثلاً، لنفرضْ أنَّ هناك كارثةً قد حصلت، كانفجارٍ راح ضحيَّته العشرات، فمن الطبيعيّ أنْ ينشرَ عنه الناس على صفحاتهم، لأنّه موضوع مهمّ ورائج، وليتحدَّثوا عن حزنهم وتأثّرهم بهذا الحدث، لنشرِ التوعية عمّا حدث، أو تضامناً مع الضحايا. لكنَّ جزءاً من هذا الفعلَ في الحقيقة هو استعراض لأنفسنا- حتى لو تمَّ ذلك بنيَّةٍ طيّبةٍ صادقة. ضمنَ هذا النمط الذي أصبح "طبيعياً"، نشاركُ حزننا الصادِق، لكن لنُكافأ على التضامن بـ"اللايكات" والمشاركات، والمزيد من توكيدِ الآخرين على مدى حساسيّتنا وإنسانيّتنا. بعدَ أن نشعرَ بهذه الغبطة والمكافأة، يتغيَّر شكلُ حزننا الصادق، تعطّشاً لذاك الاهتمام. ينطبقُ ذلكَ على أيّ منشورٍ شاركنا فيه رأيَنا، أو حتى قلنا فيه نُكتة لاقَت رواجاً؛ يُصبحُ أصحابُ سُلطةِ اللايكات حاضرين في رؤوسنا.
حينَ أعطّل حساباتي، أشعرُ بحريّةٍ تجتاحني من كلّ هؤلاء، ومِن حاجتي- مثلهم- للتقييم المستمرّ، ومن استيائي بفعل ما ينشره الآخرون، وقلقي ممّا يظنّونه عنّي، وكيف تختلفُ حيواتهم عن حياتي. يصبحُ سؤال "ليش اختفيتِ؟" باعثاً للسعادة، لأنَّه يؤكد لي أنَّ جزءاً مني اختفى قليلاً ليرتاح. وفي حياةِ الأوفلاين مديحٌ كثيرٌ ليُقال.. إلى أنْ أضعُفَ ثانيةً وأفعِّلَ حساباتي.