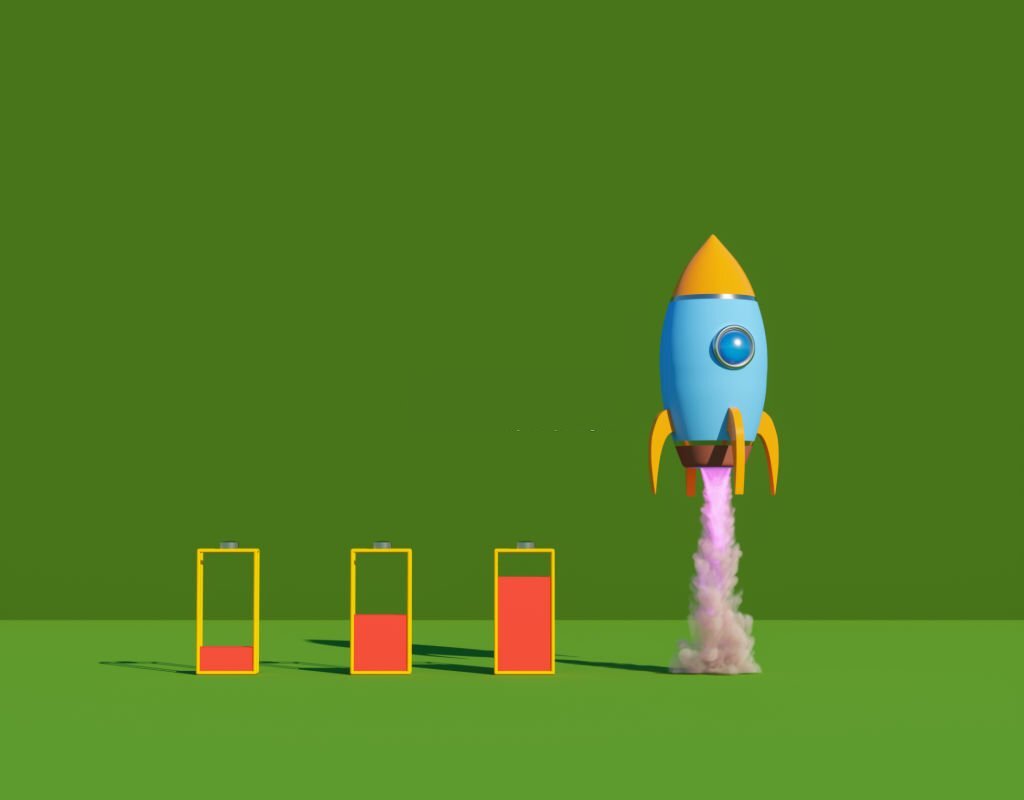تبدو الحياة مُرهقة، نعيش زمناً يحتشد بالتناقضات واللايقين. نراقب مصائر الآخرين ونجاحاتهم، نحنُ أيضاً لدينا أحلامنا، لكنّها لا تتحقّق! نزداد حيرةً وتشويشاً، لدرجة تدفعنا للتساؤل: كيف نصل كما وصلوا؟ وكيف وصل هؤلاء دون أن يسعوا؟ ولماذا لَم نصل ونحن أولى بالوصول؟ تبدو الأمور وكأنّها تعمل بلا منطق مفهوم، فالطيبون لا مكان لهم، والمخادعون لهم مساراتٌ جاهزة للوصول.
أدّى الانكشاف على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جعلنا أكثر وعياً وإدراكاً بتجارب الآخرين وحياتهم الشخصية، إنّك ترى فلاناً ينجح بينما أنتَ تفشل، وترى مَن هُو في عمرك يترقّى في وظيفته بينما أنتَ لا زلتَ تبحث عن عمل! وأمام كلّ هذه التناقضات لا تملك إلّا التمنّي، أن تحلُم وأن تعزّز من شعورك الداخلي بأنّك تستحقّ أشياءً جميلة ستتحقّق ولو بعد حين!
تؤدّي المقارنة الاجتماعية إلى تكريس السخط وعدم الرضا، فهي بحسب علماء النفس، ليسَت مُجرّد عملية إجرائية للمقارنة بين موضوعين مختلفين أو بين ذوات مختلفة من البشر، وإنّما هي مُساءلة الذات وإعادة فهمها من خلال تقييم أوضاعها الحالية عبر مقارنتها بأوضاع الآخرين ومنجزاتهم. ينجم عن هذه العملية عَنونة جديدة للذات من قُبيل: أنا متأخّر! أنا متقدّم على أقراني! لقد ضاعت السنوات الثلاثة السابقة من عمري ولَم أتقدّم خطوة واحدة للأمام!
وحين نفشل في ردم الفجوة بيننا وبين ما حصّله الآخرون من امتيازات، فإنّنا كثيراً ما نلجأ لميكانيزمات الحسد والغضب والحقد الطبقي لتقليل الشعور بالتوتّر، وغالباً ما يتضخّم لدينا بفعل ذلك الشعورُ بالاستحقاق، كشعور تعويضي للنقص الحاصل، عبر الإيمان العُصابي والمُتوهّم بأنّنا نستحقّ أكثر من أوضاعنا الحالية، فتتضخّم الذات وتتعاظم أوهامها، وهو ما أشار له ابن مسكويه في الهوامل والشوامل حين قال: "ما تكبَّر أحدٌ إلّا عن ذلّةٍ يجدها في نفسه".
يسعى هذا المقال لفهم عقيدة عبادة المشاعر وشيوع هواجس الأماني والرغبات وتفشّي فوضى القوانين الوجودية حول استمرارية السعي وحتمية الوصول، وندّعي أنّ فهمَ هذا كلّه يتمّ من خلال تركيز جهودنا التحليلية على الكلمة المفتاحية "الشعور بالاستحقاق"، وتتبّع تحوّل هذا الشعور لشكلٍ من أشكال الخطاب المعاصر لانتشال الذات من ضياعها وضآلتها، وسنعمل في قادم الفقرات على تفكيك هذه الظاهرة إلى ثلاثة مستويات أساسية: مستوى الذات، ومستوى التديّن، ومستوى العلاقات العاطفية والاجتماعية.
عبادة الذات
والعاجِزُ مَن أتبَع نفسَه هَواها.. وتمنَّى على اللهِ الأمانِيَّ (حديث صحيح).
بينما دعت الأديان والفلسفات الكبرى الإنسان للتوجّس من داخله والحذر من اتّباع هواه، وبينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يُعلّم أصحابه أن يستعيذوا من شرور أنفسهم في الصباح والمساء، تدعو خطاباتٌ معاصرة بأن يثق الناس بأحاسيسهم، وأن يتّبعوا رغباتهم وأن يرتاحوا لمشاعرهم بوصفها دوافع نقية وبريئة وصادقة، لا ينبغي إنكارها أو مقاومتها. 
لكنّ هذه الدعوات الوردية ليست حالمة فحسب بل فيها ما فيها من خيانةٍ للعلم والحقيقة وما صرنا نعرفه عن الطبيعة البشرية، حتّى أنّ المحلّل النفسي كارل يونغ، كان يحّذر من هذا المنزلق فيقول: "من المهم اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مَضى ألّا يتغاضى البشر عن خطر الشرّ الكامن بداخلهم. إنّها حقيقة مؤلمة، لكنّها أمرٌ واقع، ولهذا السبب يجب على علم النفس الإصرار على حقيقة الشرّ ويجب أن يرفض أي تعريف للطبيعة البشرية يعتبر أنّ الشرّ البشري غير موجود أو أن يتعاطى معه بوصفه مُجرّد مسألة هامشية".1الأعمال الكاملة لكارل يونغ، الجزء التاسع، الفقرة 98. وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه: "إنَّ أوَّل ما أحذِّرُكَ نفسُكَ التي بَين جَنبيك".2جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي، الحديث التاسع عشر، 2/23.
اقرؤوا المزيد: كيف يُمكن للنبيّ يونس أن يُنقذنا؟
ثمّة ثقافة شائعة بين الأفراد بأن يتعاطوا مع رغباتهم وأمانيهم الداخلية بوصفها شرعية بالضرورة، خاصّةً حين تكون هذه الرغبات مُغطّاة بقوالب الخير والنوايا الحَسَنة. تكمن المشكلة في هذه المقولات، أنّها تتضمّن عدداً من المعاني الضمنية: أولاها؛ كل ما أتمنّاه أنا، كل رغباتي، كل ما أحلم به، هو أمر جيّد وهو الخير بعينه، وهو ما سيجلب لي النجاة في الدنيا والآخرة، ولهذا يجب أن يتحقّق. ثانيها؛ طالما أنّ ما أتمنّاه أمرٌ طيّبٌ (حلال ومُباح: وظيفة، نجاح، زواج…) فإنّ الله سيُحقّقه لي الآن أو لاحقاً، وإلّا فلماذا يجعلني أتمنّاه؟
عزيزي المتسائل، عند هذه النقطة تحديداً، تُلقي بنفسك في بئرٍ مُظلِم من الاستحقاقات الشعورية حين تجعل من أمانيكَ حقوقاً مع أنّه تعالى يقول {ليس بأمانيكم ولا بأمانيّ أهل الكتاب} [النساء:123]، إذ ليس التحصيل بالتمنّي وإن شئت اقرأ {أم للإنسان ما تمنّى} [النجم:24] التي قال ابن كثير في تفسيرها: "أي ليس كلّ مَن تمنّى خيراً.. حَصَلَ له".
كيف ينشأ الشعور بالاستحقاق؟
بحسب معجم المصطلحات النفسيّة، فإنّ الشعور بالاستحقاق يعني الاعتقاد غير المبرّر بأنّ لديكَ كامل الأحقّية بالحصول على شيءٍ ما والإيمان بأنّك يجب أن تُعامَل مِن قِبَل الآخرين بطريقةٍ خاصّة واستثنائية وليس كباقي البشر. من الضروري التمييز هُنا أنّ الشعور بالاستحقاق يجعلنا ننظر للأشياء الخارجة عنّا بوصفها "حقّاً مكتسباً".
ينتمي الشعورُ بالاستحقاق لعالَم الطفولة، ولشعور متوهّم بأهمية الذات وتضخّم الأنا. وعوضاً عن السعي لمصارعة الوجود وتلبية الرغبات من خلال معادلات الاجتهاد والكفاح والمثابرة ودخول حلبة التنافس عبر الجدارة والكفاءة، يظلّ الشخص عالقاً في مرحلة طفوليّة مفادها: كلّ ما يتولّد في داخلي من رغبات هي حقوق يجب أن يسعى الوجود وكلّ ما فيه لتلبيتها.
لا يعمل الشعور بالاستحقاق كدافعٍ فحسب، بل أيضاً كمُبرِّر للعديد من السلوكيات والتصرّفات، وأكثر من ذلك كمنطق اجتماعيّ في حالة الأقلّيات والفئات المُضّطهدة ومَن يرغب بالانسحاب من معادلة الجدارة لصالح التمييز الإيجابيّ. يشبه ذلك إلى حدّ بعيد الشخص الذي يخترق الصفّ من أمامك، بينما تنتظرُ أنتَ دورَك لتُحاسب على مشترياتك، إنّه يعبُرُكَ ويتجاوزك لقناعة لديه وافتراض ضمنيّ في داخله بأنّه أحقّ من باقي الناس بمعاملة خاصّة، وكأنّه يقول للآخرين: "أنتَ لا تعرف شيئاً عن مقدار المعاناة التي واجهتها في حياتي، أنتم لا تعلمون شيئاً عن طفولَتي، عليكم أن تُراعوا ما مررتُ به".
ألا أستحقّ أن أصل كما وصل الآخرون؟
لماذا يحظى صديقك بكلّ هذا الإعجاب من الآخرين؟ ألا تستحقّ أنتَ أيضاً أن يُحبُّكَ الآخرون؟ لماذا تتحقّق أماني بعض الأشخاص الذين تتابعهم على صفحات التواصل الاجتماعي ولا تتحقّق أمنياتك أنتَ الإنسان المجتهد والخلوق؟ لماذا تترقّى فلانة في وظيفتها وأنتِ تعرفين جيداً حجم النفاق الذي تحمله في داخلها؟ وكيف استطاعت تلك الفتاة تحصيل برنامج الدراسات العليا المميّز وأنتِ أولى به منها؟ ألستُ خيراً منهم أنا الطيّب الذي أواظب على صلاتي ونزاهتي الأخلاقية، مع هذا، ما زلتُ أتمرّغ في تعاسَتي وفشلي وخيباتي؟ متى ما بدأت التفكير بهذه الطريقة والتساؤل عمّا تستحقّه أنت وعمّا يستحقّه الآخرون، تحسّس مُسدّسك التزكويّ، فأنتَ تعود بنفسك لمُنزَلَقِ الخطيئة الأولى، للوضع الشيطاني الأسوأ، إذ إنّ أول تعبير صريح للشعور بالاستحقاق في الوجود كان جوهره تفكيراً مماثلاً عند الشيطان، إذ {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ} [ص:76].
اقرؤوا المزيد: "المُشكلة ليست فيك، المُشكلة في الآخرين"!

تخبرنا مجموعة من الدراسات الحديثة في حقل علم النفس والإدراك الدّيني أنّ تغذية الشعور بالاستحقاق وتعزيز طريقة التفكير القائمة على المعاملة التفاضلية (كيف ينبغي أن يُعاملني الله وكيف ينبغي أن يُعامل الله الآخرين) بأنّك تستحقّ معاملة خاصّة، مرتبطة بمشاعر -ولو خفيّة- بالسخط على الإله، كما ترتبط بمشاعر الغضب والاحتجاج الوجودي والمعاناة. حتى في السياقات التي لا علاقة لها بالكفاءة والمهارة والجدارة، فإنّ الأشخاص الذين يشعرون بالاستحقاق يتوقّعون من الكون أو الإله أن يُنصفهم وأن يطاوعهم وأن يزيد من فُرَصهم وإن كانوا غير جديرين أساساً بها. وهذه الخلاصة مهمّة كي ندرك أنّ الشعور بالاستحقاق لا علاقة له بمدى كفاءة مَن يشعرون به، أو عمّا إذا كانوا يستحقّون أصلاً الفُرَص التي يتقدّمون لها أم لا، إذ هو في النهاية شعور مُتوهّم وتضخّم غير مُبرّر للذات.
ما الذي يفعله وَرَم الاستحقاق بالعلاقات؟
بإمكانكَ أن تتخيّل أنّ الأزواج والعشّاق في علاقاتهم العاطفية كثيراً ما يتعرّضون لمشكلات ظرفية (situational) نتيجة سوء فهم أو مرور بضغوطات معيشية مُعيّنة، وهي ليست مشكلات جوهرية (essential) بالضرورة، وكثيراً ما تكون المشكلات الظَرفية مشحونة بالغضب والانفعالات السلبية المُؤقّتة، وتحتاج بعض الوقت كي تهدأ ويستعيد الطرفان القدرة العقلانية على تحليل المشكلة وإصلاحها. لكن ما الذي يحدث في حال ذهب الطرف الغاضب فوراً إلى معالجٍ نفسيّ لا يعي فكرة الانفعالات المَوقفية والمشكلات الظرفية؟
حسناً، إنّه قد يوافق شعور الغضب عند الطرف الذي يُراجعه، بأن يقول له: أنا أتفهّم شعورك، لديكَ كامل الحقّ بأن تغضب. وتوكيد المشاعر غالباً ما يُضفي شرعية على الانفعال السلبي، ومن ثمّ يزيد من شعور الشخص الغاضب بالاستحقاق، وهو ما سيزيد إحصائياً من فُرَص الطلاق أو الانفصال.
لعلّك تقول في نفسك، أليس من المفترض أن يكون المعالجون النفسيون على وَعي بهذا الإشكال؟ أو لعلّك تقول ليس هناك معالجون نفسيون يتصرّفون بهذه الطريقة! وهذا محض ادّعاء لا دليل عليه. للأسف، فإنّ ثقافة الاستحقاق وتوكيد المشاعر اخترقت العيادات النفسية بطرقٍ مخادعة وغير علمية، وهو ما دفع عدداً من النُقّاد إلى تحذير المعالجين النفسيين من الوقوع بمُنزَلَقات الاستحقاق والانجرار خلف شكاوى المراجعين، ومطالبتهم بالتأنّي قبل توكيد مشاعر الأزواج الغاضبين وإضافة شرعية على مشاعرهم قبل تفحّص البُنى المعرفية السابقة لهذه الانفعالات والمشاعر، لأنّها قد تكون تصوّراتٍ خاطئة وظالمة بالأساس.

غالباً ما يُساء فهم الاحتياجات العاطفية في ظلّ مَناخٍ مُتشبّع بثقافة الاستحقاق، وهو ما يُطلِق عليه البروفيسور في علم النفس ستيفن ستوسني "لعنة الاحتياجات العاطفية"، ويقصد بها اللعنة التي تُحدثها عملية التعاطي مع الاحتياجات العاطفية بوصفها حقوقاً، وذلك من خلال المنطق التالي: أنا أشعر بهذا الشعور، هذا يعني أنّني أحتاجه، وطالما أنّ هذا الشعور هو احتياج عاطفي فهو حقٌّ مكتسَب لي، وبناءً عليه، يجب عليك كشريك عاطفيٍّ لي أن تسعى لتحقيقه، وإذا لم تقم بتلبيته سأعاقبك بطريقةٍ أو بأخرى. بحسب ستونسي، وكذلك المختصّة في علم نفس العلاقات كاثرين أبونت، فإنّ مشاعر البشر وخاصّةً الأشخاص البالغين لا يجب التسليم لها، ولا ينبغي توكيدها دائماً، إذ إنّ المشاعر كثيراً ما تكون خاطئة، وقد تُبنى على إدراك مغلوط للموقف الاجتماعي، وقد تكون مُجرّد إسقاطات لاواعية محُمّلة بحمولات مواقف سابقة، كما قد تتحفّز لأسباب مخادعة، وكثيراً ما تُوظّف للتلاعب العاطفي بالآخرين وابتزازهم.
ولا يقتصر خطاب الاستحقاق على عبادة المشاعر، فقد يفضي أيضاً إلى تدمير الزيجات وتفكيك العديد من الأُسَر، وذلك بتنويعات مختلفة من خطاب الاستحقاق، أبرزها استحقاق السعادة (المهم أن تكوني سعيدة، وإذا لَم تكوني كذلك فهذا يعني أنّكِ في المكان الخاطئ). وقد تنبّهت المعالجة النفسية المختصّة بالأزواج إستر بيريل، لهذا الفخ الشائع، إذ أشارت إلى خطورة هاجس السعادة ودوره في تدمير استمرارية العلاقات بمجرّد تعرّض الفرد للألم أو المعاناة العاطفية. والأخطر في خطاب استحقاق السعادة، هو أنّه يقلّل رضا الفرد عن علاقته الحالية فيجعل المُتحابين أكثر تعاسة، من خلال الانفتاح على مجموعة لا مُتناهية من الاحتمالات والتخيّلات. أيّ أنّ التحوّل الأساسي في التفكير بالعلاقات العاطفية اليوم، يتمثّل بالانتقال من فكرة التخلّص من الألم (يجب أن أُنهي هذه العلاقة الآن لأنّني لا أشعر بالسعادة) إلى إطارٍ جديد متمثّل بهاجس استحقاق سعادة أخرى محتملة، أكبر وأمتع، والذي تجسّده عبارة: ربّما يجب أن أُنهي هذه العلاقة لأنّني قد أكون أكثر سعادةً في مكانٍ آخر.
بدائل الاستحقاق: المثابرة والتواضع ومخالفة النفس
تخبرنا دراسات علم النفس أنّ البشر يميلون تلقائياً لتضخيم ذواتهم، وهو ما يُسمّى بانحياز تعزيز الذات. معنى ذلك، أنّ البشر بطبعهم يرون أنفسهم أكثر مهارة وطيبة وأخلاقية واحترافاً مقارنة بما هُم عليه على أرض الواقع. وهذا الانحياز يستلزم بالضرورة أدواتٍ سلوكية ومعرفية عكسية، كي لا نغرق بتوهّم ما هو غير واقعي بالأساس، وكي لا نأسر أنفسنا بزنازين الوهم والزيف. من هنا تأتي ضرورة التزكية واستعادة منظومات التربية الروحية التي تزخر بها ثقافتنا، أمام ثقافة يصفها النُقّاد بأنّها ثقافة نرجسية وأمام عصر يصف الباحثون أجيالَه بأجيال الاستحقاق.
اقرؤوا المزيد: الإكراه على دين الليبرالية
لمقاومة ثقافة الاستحقاق، علينا أولاً أن نُعلي من قيمة التواضع وأن نرفض أي خطاب يسعى لإقصاء فضيلة التواضع بوصفها مُكافئاً لتدنّي تقدير الذات. إذ تشيع في وقتنا المساواة بين فضيلة التواضع وتدنّي تقدير الذات، وكذا تتمّ تسوية مُجالسة الذات والعُزلة الصحّية بمفاهيم الانطواء السلبي والشعور بالوحدة. بل إنّ هناك مَن لا يُريدك أن تشعر بالخطأ أساساً، إذ تُساوي بعض الخطابات -من منطلقات الإيجابية السامّة- بين الشعور بالذنب وجلد الذات، ولهذا حين تُخطئ لا يجب أن تشعر بالذنب أساساً، وإلّا فأنتَ تجلد ذاتك وتعاقب نفسك وتسحق تقدير الذات عندك. وذلك بالرغم من وجود دراسات تُشير إلى أهمّية الشعور بالذنب -ضمن حدود مُعيّنة- كموجّه أساسي للصدق، وكدافع لتحسين السلوك وتصحيحه.
ولتحصين أنفسنا من مزالق الاستحقاق، علينا دائماً أن نقف ابتداءً موقفاً حذراً من أهواء النفس ورغباتها، وهو ما أشار له صاحب البُردة: "وخالِف النفسَ والشيطان واعصهما.. وإن هُما مَحضاك النُصحَ فاتّهم". فالأصل أن نُسائل رغباتنا وأن نتفحّص أمانينا وأن نبذل جُهداً تنقيبيّاً في البحث عن مصدر هذه الأماني والرغبات ومُؤدّاها. بل إنّه أحياناً، قد يكون الأولى أن نُخالف ما تميل إليه النفس والتوجّس ممّا تستسهله، وقد أشار إلى ذلك ابن عطاء الله السكندريّ في حِكَمه حين قال: "إذا التبس عليك أمران.. فانظر أثقلهما على النفس فاتّبعه، فإنّه لا يثقل عليها إلا ما كان حقّا".
أخيراً، فتجريد الاستحقاق يكون بأن لا ترى لنفسك فضلاً، وأن لا تُعجِبُكَ نفسك، وأن ترى أنّ الأمر كلّه لله، يرزق مَن يشاء وينزع الملكَ ممّن يشاء، وأنّ المقادير والمصائر بين يدي الحكيم العزيز يصرّفها كيف يشاء، وأن تُلحِقَ هذه القناعة بالسعي والمثابرة والاجتهاد في حياتك تبتغي وجه الله ورضاه لا إعجاب النّاس وثنائهم عليك، متحرّراً من هواجس الوصول ومتسامياً على ضرورة اعتراف الآخرين باستثنائيتك وجدارتك.